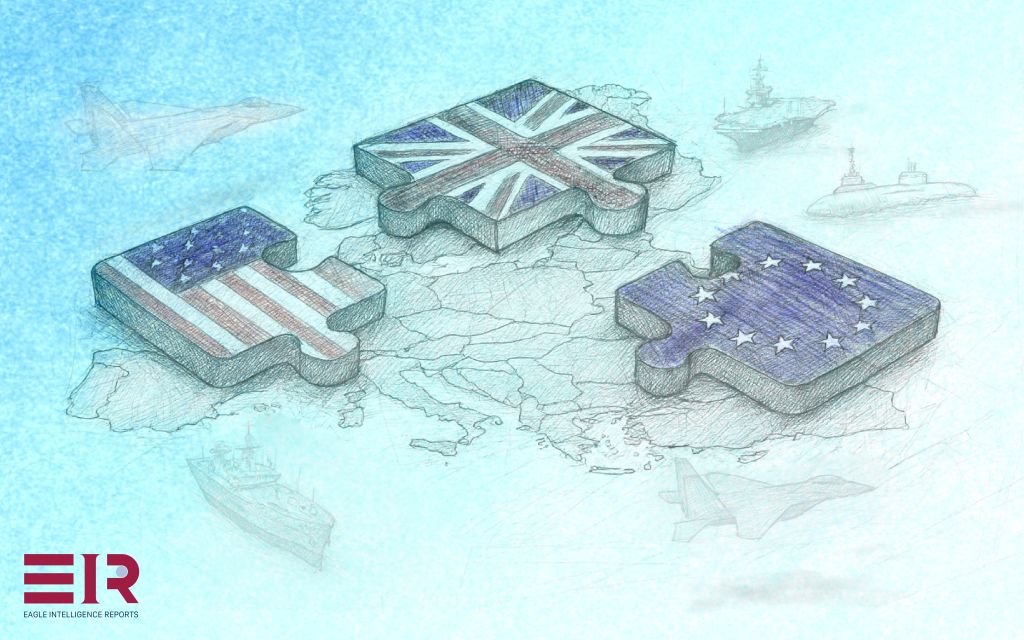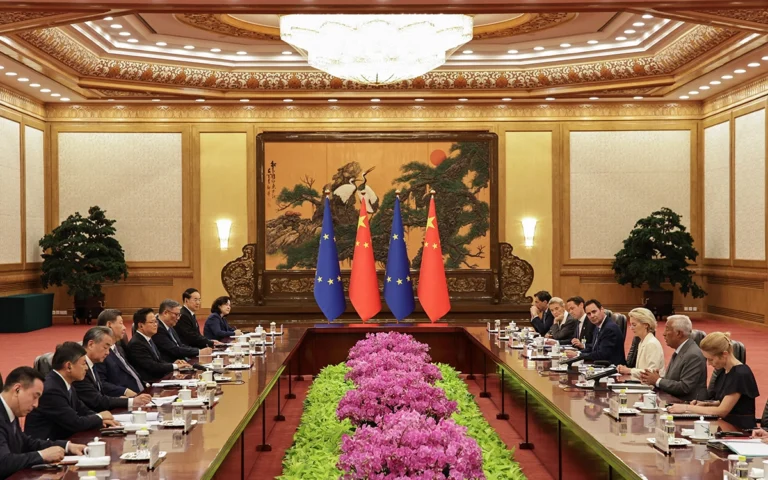تواجه أوروبا اليوم اختباراً استراتيجياً حاسماً، مع اقتراب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا من عمق القارة، في وقت يخيّم فيه الغموض على مستقبل التحالف عبر الأطلسي، بالتزامن مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وفي قلب هذه التحوّلات، تقف بريطانيا -التي تمثل ركيزة عسكرية أساسية في حلف الناتو- أمام تحدي إعادة تموضعها الجيوسياسي، فعلى الرغم من محاولاتها الحذرة لتجديد التواصل مع الاتحاد الأوروبي، إلا انها لا تزال مقيدة بإرث البريكست وتعقيدات سياساتها الداخلية، إذ يبقى المسار الذي ستختاره لندن بين واشنطن وبروكسل عاملاً مهماً في تحديد دورها المستقبلي، بل وفي رسم ملامح النظام الأمني الأوروبي الجديد.
ترامب والغموض عبر الأطلسي
لم يعد بالإمكان اعتبار حلف الناتو درعاً مضموناً، لطالما اعتمدت قوته على الموثوقية السياسية بقدر اعتمادها على القدرة العسكرية، حيث دفعت تقلبات ترامب الحكومات الأوروبية إلى مواجهة حقيقة صارخة: “لا يمكن الاستعانة بمصادر خارجية بالكامل لضمان أمنها عبر الأطلسي”، ونتيجة لذلك، يُعاد النظر في ميزانيات الدفاع، وتُعاد حسابات انتشار القوات، وتُكتب الخطط الاستراتيجية من جديد لحظة بلحظة.
حلف الناتو لم يعد درعاً مضموناً لطالما اعتمدت قوته على الموثوقية السياسية بقدر اعتمادها على القدرة العسكرية
تشعر بريطانيا بهذا الاضطرابات بشدة، حيث يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر -المدافع الشرس عن النظام العالمي الليبرالي- إلى طمأنة الولايات المتحدة بالتزام بريطانيا، مع الإشارة إلى بروكسل واستعدادها للتعاون العملي، ومع ذلك، يراقب قادة أوروبا الوضع عن كثب، إذ يتعين على لندن الآن التعامل مع حليف يزداد ضعفاً عبر الأطلسي، وشريك أوروبي تتزايد أهميته، ما يسهم بتشكيل دور بريطانيا والنظام الأمني الناشئ في القارة.
الناتو العمود الفقري واستقلالية أوروبا تتصاعد
في الوقت الراهن، لا يزال الناتو الإطار الأساسي لأوروبا، إلا أن الحرب في أوكرانيا كشفت عن نقاط قوته وحدوده في آنٍ واحد، وضمن لغة الأرقام تتفوق الولايات المتحدة بشكل كبير على باقي حلفائها في الناتو، حيث أنفقت 935 مليار دولار (787 مليار يورو) على الدفاع في عام 2024 ما يعادل 3.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، أي نحو ضعف الميزانيات الدفاعية المجمعة لبقية دول الحلف.
ومع ذلك، كشفت حرب أوكرانيا حقيقة مُرّة تقول: “الاعتماد على واشنطن وحدها لم يعد كافياً”، كما تواجه أوروبا اليوم أيضاً مفارقة دقيقة، تقول: “يجب أن تظل معتمدة على الناتو، وفي الوقت ذاته تستعد للدفاع عن نفسها في حال تراجع دور الحلف”.
في جميع أنحاء أوروبا، تُشير الأرقام إلى ضرورة مُلحة، لا سيما فيما يتعلق بالثنائي فرنسا وألمانيا، ففي برلين، كسر المستشار فريدريش ميرز أحد المحرمات التي استمرت لعقود عبر تخفيف القيود المالية، واستخدام صناديق خاصة لدفع الإنفاق الدفاعي إلى ما يتجاوز حدود الدين المنصوص عليها في الدستور، وتعهد بإنشاء أقوى جيش في القارة باستثمار بلغ 649 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة.

بالتزامن مع ذلك، أعلن ميرز والرئيس ماكرون عن طموحهما لرفع الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى الحالي لحلف الناتو، حيث تعمل فرنسا -الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بردع نووي مستقل ونموذج صناعي دفاعي متكامل- على زيادة إنفاقها الدفاعي من 59 مليار يورو في عام 2024 إلى 67 مليار يورو بحلول عام 2030 بموجب قانون البرمجة العسكرية.
في ظل هذا المشهد، يجب تقييم الوضع الاستراتيجي لبريطانيا بمعزل عن سياقه، بل بالمقارنة مع السيادة الاقتصادية القائمة على السوق في باريس، والزخم الصناعي والمالي المتجدد في برلين، وهو ما تبدو ملامحه واضحة بالفعل.
لا يمكن تقييم الوضع الاستراتيجي لبريطانيا بمعزل عن سياقه، بل بالمقارنة مع السيادة الاقتصادية القائمة على السوق في باريس، والزخم الصناعي والمالي المتجدد في برلين
تعهدت لندن برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع طموح للوصول إلى 3% بحلول عام 2034، وذلك إلى جانب خطط طموحة لإضافة اثنتي عشرة غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية، في إطار شراكة “أوكوس” الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
في الشرق، يتجلى هذا التوجه بشكل أوضح، فبولندا ودول البلطيق تنفق ما يفوق بكثير سقف الناتو، مقتنعةً بأن الجغرافيا لا تترك لها خياراً، وبالنظر إلى الصورة العامة، فإن هذا التحول غير مسبوق، فقد زادت عشر دول أوروبية أعضاء في الناتو ميزانياتها الدفاعية بأكثر من 20% في العام الماضي وحده، وهو مستوى إعادة تسليح لم نشهده منذ الحرب الباردة، وما بدا مستحيلاً في أوروبا زمن السلم، أصبح، بين عشية وضحاها تقريباً، واقعاً جديداً وأمراً مألوفاً.
والآن، بدأ الاتحاد الأوروبي، الذي كان لفترة طويلة لاعباً هامشياً في مجال الدفاع، باتباع نفس النهج.
أقرّت المفوضية الأوروبية عبر خطة “إعادة تسليح أوروبا”، إنفاقاً دفاعياً جديداً يصل إلى 800 مليار يورو، وتعتزم أكثر من نصف حكومات الاتحاد الآن تجاوز حدود الإنفاق التي كانت تُحدد سابقاً الانضباط الاقتصادي للاتحاد.
وتُشير مبادرات مثل آلية “SAFE” (التسهيلات الأوروبية الاستراتيجية للتسلح) البالغة قيمتها 150 مليار يورو إلى رغبة حقيقة في الدمج بين القوة المالية والصناعية والطموح الاستراتيجي.
دور بريطانيا في SAFE
مع ذلك، فإن الطموح وحده لا يكفي؛ فبدون المصانع وسلاسل التوريد والتنسيق الصناعي اللازم، يبقى الاستقلال الأوروبي مجرد طموح لا واقع، وهنا تبرز أهمية آلية SAFE ودور بريطانيا فيها لا سيما بعد أن وقّع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شراكة دفاعية وأمنية جديدة في مايو 2025، والتي ستُرسّخ التعاون الأمني، والاتفاق يعيد ضبط العلاقة بأربع طرق:
أولاً، ينشئ الاتفاق آليات استشارة منتظمة: إذ سيجتمع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بانتظام مع وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين، وسيُرسي كبار المسؤولين من كلا الجانبين أسس التعاون.
وثانياً، يفتح الباب أمام مشاركة بريطانيا في المشتريات المشتركة للاتحاد الأوروبي رغم أن بريطانيا خارج السوق الموحدة، ولا تزال التفاصيل بحاجة إلى دراسة، لا سيما ما إذا كانت شركات الدفاع البريطانية ستُحتسب ضمن متطلبات اتفاقية SAFE التي تنص على أن 65% من تدفقات المشتريات موجهة إلى الشركات الأوروبية.
وثالثاً، يُحدد الاتفاق نية توسيع التعاون: يمكن لبريطانيا المشاركة في بعثات الاتحاد الأوروبي المدنية والعسكرية، والتعاون مع وكالة الدفاع الأوروبية، وتبادل الأفراد للتدريبات المشتركة.
ورابعاً، يُحدد الاتفاق أجندة واسعة النطاق لتعزيز التعاون، بدءاً من أوكرانيا، وغرب البلقان، والقطب الشمالي، وصولاً إلى تنسيق العقوبات، والدفاع السيبراني، والأمن البحري، وحتى التحديات الأمنية المرتبطة بالمناخ.
بالنسبة للندن، يُمثل هذا التطور فرصةً وتحدياً في آنٍ واحد، فقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى استبعادها رسمياً من عملية صنع القرار في الشؤون الدفاعية الأوروبية، تاركاً إياها معتمدةً على قنوات حلف شمال الأطلسي والتعاون غير المباشر.
إذا كان هناك درس واحد كان ينبغي لأوروبا أن تتعلمه من السنوات الثلاث الأولى من الحرب في أوكرانيا، فهو أن التحالفات العسكرية لا يمكن أن تنجح من دون عمق صناعي.
لكن أوروبا لا تبدأ من الصفر، فالقارة تستضيف خمساً من أكبر عشرين شركة دفاعية في العالم، وقد وسّعت العديد منها إنتاجها بالفعل منذ الغزو الروسي، وقدرتها الإنتاجية موجودة، لكن ما كان ينقصها حتى الآن هو الطلبات التي تُمكّن هذه المصانع من العمل بكامل طاقتها.
وهنا يأتي دور المبادرة الأوروبية الجديدة، فعلى الورق، تُعد آلية SAFE أداة طموحة صُممت لمعالجة الضعف الهيكلي الذي عانى منه مشروع الدفاع الأوروبي لعقود، من تشتت في عمليات الشراء، وتكرار في القدرات، ونقص مزمن في الاستثمارات، و SAFE تهدف إلى توجيه أموال الاتحاد الأوروبي نحو توسيع إنتاج الذخيرة، وتوحيد الطلبات بين الدول الأعضاء، ودفع أوروبا تدريجياً نحو مستوى من المرونة الصناعية يُشبه ما تتمتع به الولايات المتحدة منذ زمن طويل.
وهنا يصبح دور المملكة المتحدة حتمياً، فرغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال قطاع الدفاع البريطاني جزءاً لا يتجزأ من سلاسل التوريد الأوروبية، حيث تُورّد شركات الطيران والفضاء البريطانية العملاقة مكوناتٍ لبرامج المقاتلات الفرنسية الألمانية؛ ولا يزال المقاولون البريطانيون يتعاونون مع شركات أوروبية في بناء السفن وأنظمة الصواريخ؛ حتى إعادة التنظيم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يُفكّك الشبكة الصناعية التي نشأت على مدى عقود من التعاون، لذا، فإن استبعاد بريطانيا من اتفاقية SAFE لن يكون مجرد قرار سياسي، بل سيكون عملاً من أعمال الإضرار الذاتي اقتصادياً بالنسبة لجهود أوروبا في إعادة التسلّح.
ومع ذلك، فإنّ المشاركة محفوفة بالمخاطر السياسية، وقد ألمحت المفوضية الأوروبية إلى أن لندن قد تستفيد من مبادرة SAFE، لكن بروكسل ليست في عجلة من أمرها لمنح بريطانيا تصريحاً مجانياً، ومن المرجح أن تأتي المشاركة البريطانية مشروطة ربما بمساهمات مالية مباشرة، أو ربما بقيود على سلطة اتخاذ القرار.
المفارقة أن أوروبا نفسها ستكون المستفيد الأكبر من مشاركة بريطانيا، فثقل بريطانيا الصناعي من قوتها العاملة الماهرة، وتقنياتها المتقدمة، وأسواقها التصديرية، قد يُضاعف من تأثير هذه الأداة، وبدونها، يُخاطر اتفاق SAFE بأن يصبح برنامجاً أوروبياً آخر حسن النية ولكنه ضعيف الفعالية.
الثقل الصناعي البريطاني يضاعف تأثير مبادرة SAFE الأوروبية فبدونها تخاطر بأن تصبح مجرد برنامج أوروبي آخر حسنة النية ولكنها ضعيفة الفعالية
حدود الاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
حتى مع اتفاقية SAFE، ومع التصريحات الجديدة حول التعاون والمؤتمرات الصحفية الرنانة في بروكسل ولندن، لا تزال اتفاقية الدفاع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أساساً أكثر منها حصناً منيعاً، فالتاريخ يُعلّمنا أن نكون حذرين تجاه الإعلانات الأمنية الأوروبية، فمنذ إعلان سان مالو عام 1998، الذي وعد ببناء هوية دفاعية أوروبية، إلى إطلاق التعاون الهيكلي الدائم (PESCO) عام 2017، كشفت القارة مراراً وتكراراً عن مبادرات تُعتبر إنجازات لكنها بقيت دون التنفيذ الفعلي.
على عكس الناتو، الذي يحافظ على التزامات تعهدية، فإن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هو اتفاق سياسي، عرضة لتقلبات السياسات الداخلية، فقد تختار حكومة بريطانية مستقبلية، مدفوعة بضغوط شعبوية أو تقشف اقتصادي، أن تنأى بنفسها مرة أخرى عن الالتزامات الأوروبية، وهو احتمال لا يبدو مستبعداً على الإطلاق في ضوء استطلاعات الرأي الحالية.
والتحدي الآن يتمثل بتحويل الرمزية إلى واقع ملموس، وهذا يعني توفير المال، وتشغيل المصانع على نطاق واسع، وتأهيل جيوشاً قادرة على الانتشار بسرعة، وسياسيين مستعدين لشرح أهمية كل هذا لمواطنيهم.
تحالفات مرنة وقوة شبكية
لكن إذا كانت العضوية الرسمية في الاتحاد الأوروبي صعبة، فإن التحالفات غير الرسمية تُعدّ الموطن الطبيعي لبريطانيا، حيث برزت القوة الاستطلاعية المشتركة (JEF)، بقيادة المملكة المتحدة، والتي تضم دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، كواحدة من أكثر التجمعات الدفاعية ديناميكية في أوروبا، فهي تُجري تدريبات منتظمة، وتنتشر بسرعة، وتعمل بمرونة غالباً ما تفتقر إليها بروكسل.
هناك تحالف آخر، يُسمى الخماسي الأوروبي E5 (المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا)، يعمل كهيئة داخل حلف الناتو، أي دائرة داخلية قادرة على تنسيق الاستراتيجيات عندما تكون آليات التحالف بأكملها بطيئة للغاية، حيث تُجسّد هذه المجموعات ميزة بريطانيا الراسخة: القدرة على الاجتماع، والقيادة، والعمل خارج الهياكل المؤسسية الجامدة.

إلى جانب الأطر متعددة الأطراف، عززت بريطانيا حضورها الأوروبي من خلال تجديد اتفاقياتها الأمنية الثنائية، مع العلم أن اتفاقية “ترينيتي هاوس” المبرمة في أكتوبر 2024 مع ألمانيا تُعزز القدرة الدفاعية المشتركة والتشغيل البيني، وهي علاقة تعززت أكثر في منتصف عام 2025 من خلال اتفاقية تطوير أسلحة دقيقة بموجب معاهدة كنسينغتون.
علاوة على ذلك، في القمة الفرنسية البريطانية التي عُقدت في يوليو 2025، تم تحديث معاهدات “لانكستر هاوس” لتعزيز التنسيق النووي، وإحياء القوة المشتركة، وتوسيع التعاون في المجالات السيبرانية والفضائية والصناعية.
بالنسبة لأوروبا، لا تُعدّ هذه التحالفات بديلاً عن حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، بل مُكمّلاً لهما، فهي تُتيح استجابة سريعة بينما تستغرق المؤسسات الأوسع وقتاً أكثر في المناقشات، أما بالنسبة لبريطانيا، فهي بمثابة شريان حياة ووسيلة لإثبات أهميتها دون الحاجة إلى الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي، وطريقة لترسيخ مكانتها في أوروبا مع الحفاظ على استقلاليتها.
وهناك عنصر آخر تُقدّمه بريطانيا لأوروبا، وهو الردع، فإلى جانب فرنسا، تظلّ بريطانيا واحدة من قوتين نوويتين أوروبيتين فقط.
في الأوقات العادية، تُعتبر هذه الحقيقة مجرد ضجيج في الكواليس، أما في عصر الشك الأمريكي وأوهام بوتين الإمبريالية، فتكتسب هذه الحقيقة أهمية جديدة، فإذا ضعفت ضمانة واشنطن، فقد تُصبح الترسانة النووية البريطانية آخر درع موثوق لأوروبا، ولكن من الناحية السياسية، فإن أي اقتراح بأن تصبح بريطانيا الضامن النووي لأوروبا سيُشعل جدلاً حاداً في الداخل، فإن هذا الاحتمال بحد ذاته يُبرز مدى تغير النظام الأمني في القارة.
بريطانيا بين واشنطن وبروكسل
مع كل هذا الحديث عن تعزيز اندماج بريطانيا في أوروبا، يجب ألا ننسى أن “العلاقة الخاصة” مع واشنطن لم تكن مجرد كلام، بل هي المبدأ الأساسي للدفاع البريطاني، فمنذ الحرب العالمية الثانية، مروراً بالعراق وأفغانستان، حددت لندن دورها العالمي من خلال منظور التحالف الأمريكي.
وقد رسّخت شبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية المعروفة بـ”العين الخمسة”، الاندماج المستمر للضباط البريطانيين في القيادة الأمريكية، والتطوير المشترك لأنظمة الأسلحة، هذا التبعية بدرجة لا مثيل لها لدى أي حليف أوروبي آخر.
لا يزال هذا التوافق قائماً، لكنه أصبح يحمل مخاطر جديدة، فقد أدخلت عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حالة من عدم اليقين على التحالفات التقليدية، ومع ذلك، حتى بعد ترامب، تتجه السياسة الأمريكية نحو إعطاء الأولوية الاستراتيجية للصين، ما يعني أن أوروبا قد تواجه انسحاباً أمريكياً طويل الأمد، بغض النظر عمن سيتولى الرئاسة، وإذا علمتنا الانتخابات السابقة شيئاً، فهو أن النزعة الدولية لم تعد بطاقة رابحة في السياسة الأمريكية.
لذلك يتعين على الحكومة البريطانية الانخراط في عملية موازنة دقيقة، عبر تقديم تطمينات مستمرة لواشنطن، وفي الوقت نفسه إعداد أوروبا أن تلك التطمينات قد لا يكون لها وزن كبير في نهاية المطاف.
على الحكومة البريطانية الانخراط في عملية موازنة دقيقة عبر تقديم تطمينات مستمرة لواشنطن وفي الوقت نفسه إعداد أوروبا لاحتمال أن تلك التطمينات قد لا يكون لها وزن كبير في نهاية المطاف
حاول ستارمر السير على هذا النهج، فهو يطمئن نظراءه الأمريكيين بأن المبادرات الأوروبية تهدف إلى تكملة الناتو وليس تقويضه، ويتجنب الصدام العلني مع ترامب -حتى أنه يتراجع بشكل غير مباشر عن دعم انضمام أوكرانيا للناتو- حفاظاً على علاقات العمل، لكن هذا التحفّظ له ثمنه؛ إذ قد تبدو بريطانيا متفاعلة فقط، لا مُبادرة، في تشكيل الرد الغربي على روسيا، حيث يلاحظ الشركاء الأوروبيون هذا التردد، وقد يتساءل البعض منهم عما إذا كانت لندن ستُعطي الأولوية للمزاج الأمريكي على حساب الضرورة الأوروبية.
جسر أم باني أم متفرج؟
في الوقت الحالي، ليست بريطانيا نائباً مطلقاً لواشنطن، ولا سابقاً أوروبياً منبوذاً بالكامل، بل هي قوة مطلوبة، يتودد إليها حلفاء الناتو وبروكسل في آنٍ واحد، ويحسدونها على ثقلها العسكري، لكنها تعاني من قيود سياسية ومالية تُلقي بظلالها عليها.
ثلاثة سيناريوهات مستقبلية مطروحة:
السيناريو الأول، الجسر:
تُعزز بريطانيا حضورها الأطلسي، مُقرّبةً نفسها من واشنطن حتى في مواجهة رؤية ترامب العالمية القائمة على الصفقات، حيث تُصبح لندن الوسيط المحوري بين الولايات المتحدة وأوروبا، أي الجسر الذي يربط بين ترامب وبروكسل، والعكس صحيح، فتُحافظ هذه الاستراتيجية على تماسك حلف الناتو، لكنها تحمل في طياتها خطر التبعية، فإذا انسحبت واشنطن فعلاً، سينهار جسر بريطانيا.
السيناريو الثاني، الباني:
تضع بريطانيا ثقلها خلف الهياكل الأمنية الأوروبية الناشئة، لا كمتسوّلة، بل كشريك في البناء، فهي تستثمر في المبادرات الفرنسية-الألمانية، وتوسّع التكامل الصناعي الدفاعي، وتسهم في تحويل مجلس الأمن الأوروبي إلى مؤسسة حقيقية وفعالة، وفي هذا المسار، تُكمل بريطانيا دور الناتو، وتُرسّخ نفسها في قلب أوروبا الاستراتيجي، وتضمن أن يبقى ردعها النووي عنصراً أساسياً في دفاع القارة.
لكن هذا الطريق يتطلب شجاعة سياسية، واستعداداً لقبول تسويات مع بروكسل كانت تعتبر من المحرمات في حقبة البريكست، وإذا نجحت بريطانيا في ذلك، فسترتقي من شريك قائم على المعاملات إلى مهندس رئيسي للأمن الأوروبي.
السيناريو الثالث: المتفرج:
تُشلّ بريطانيا بفعل الشعبوية الداخلية، والقيود المالية، والتردد الاستراتيجي، فلا تختار أن تكون لا جسراً ولا بانياً، تتشبث بأوهام “بريطانيا العالمية” بنسختها القديمة، وتُطلق الخطابات دون أن ترفقها بالموارد، وتترك لغيرها من باريس، وبرلين، بل وحتى وارسو تزعم المشهد الأوروبي.
هذا المصير سيجعل بريطانيا ضعيف، وصغيرة جداً للتأثير في استراتيجية واشنطن، وبعيدة جداً عن التأثير في مسار أوروبا، وتدريجياً تصبح على هامش القارة ذاتها التي ساهمت يوماً في صياغة دفاعها.
من بين هذه السيناريوهات، يبدو السيناريو الهجين بين الباني والجسر هو الأكثر ترجيحاً، فالمملكة المتحدة ليست مستعدة للانعزال أو الخضوع لنزوة عبر الأطلسي وحدها، بل إنها تستفيد من الروابط الصناعية، من خلال مبادرة SAFE، ومسارات الشراء بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، واتفاقية الأمن بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الموقعة في مايو 2025 لترسيخ مكانتها كمهندس أوروبي، حتى مع حفاظها على مسارها عبر الأطلسي.
الاكتفاء بلعب دور الوسيط لم يعد مقبولاً؛ ففرنسا وألمانيا تدفعان بقوة نحو الاستقلالية الأوروبية، ما يجعل دور “الجسر الأحادي” غير كافٍ لتحقيق النفوذ الحقيقي، أما تبنّي موقف المتفرّج، فسيُهدر الفرصة التاريخية المتاحة أمام المملكة المتحدة للمساهمة في إحياء الدفاع الأوروبي.
المزج بين الباني والجسر يبدو اليوم هو الخيار الاستراتيجي المرجح لبريطانيا، حيث تجمع بين تعزيز القدرات الأوروبية والحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع واشنطن، وهذا التوازن يمثل في الوقت الراهن النهج الأمثل للحفاظ على مكانة بريطانيا ونفوذها وأمنها، إلى جانب ضمان أمن جميع الأطراف المعنية.